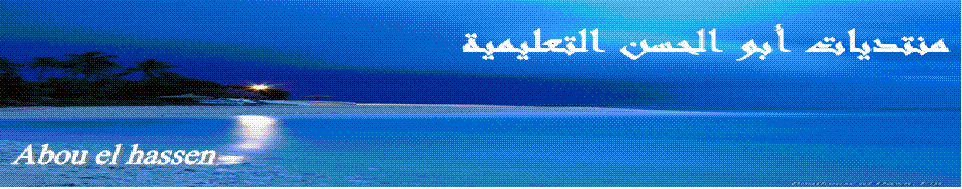مـــن أعـــــــــــــلام الجـــــــزائـــــــــــــــر
يأتي
اليوم الرابع من شهر ابريل (نيسان) مِن كل عام ليُذَكِر كلَّ مَن لا زالت
لديه ذاكرة، بيوم مشهود في تاريخ الجزائر الحديث عامة، وتاريخ ثورتها
التحريرية المباركة خاصة. ذلكم اليوم من سنة 1957، الذي أقدمت فيه عصاباتُ
الإرهاب الفرنسي في الجزائر بالاعتداء على حرمة بيت عالِم من علماء الأمة،
واقتادته -بصورة لا تليق بمقامه ولا سِنِّه- إلى مصير مجهول المكان، معلوم
القصد. اغتالته يدُ الإرهاب تلك بغير ذنب سوى أنه أراد لأمته الحياةَ
والرفعةَ، ولوطنه العزةَ والحرية.
تَمُرُّ هذه الذكرى وكثيرٌ مثلها، والناس في شُغُل عن أبطالها وصانعيها،
بل ومنهم مَن يتعمد طمسَ معالمها وإبعاد الأجيال عنها وعن عبرها. حتى كادت
تختلط الأمور على العقول، وتتشَوَّه الصورةُ أمام العيون، فتساوى أمامها
المجاهدُ والقاعد، والأمينُ والخائن، وأصبح الضحيةُ إرهابِيًا والإرهابيُّ
حَكَمًا. وكادت تَضيعُ مع ذلك معان عظيمة عاش لها الأسلافُ، وكرامة عزيزة
ماتوا لأجلها، واتجهت قلوب الكثيرين من المُسْتَغْفَلين صوب قِبلةٍ كفر
بها آباؤُهُم، ليس جحودًا وتعصبًا، بل لأنَ سَدَنَتَها أرادوا استعبادَهم
وإذلالهم،وإعراضهم عن الدين الذي ارتضاه لهم آباؤُهم، واللغة التي
استعذبتها ألسنةُ أجدادهم وصارت منهم وهم منها.
جدير بأمّة أنجبت مثل الشيخ التبسي أن تفيه حقَّه وأن تُذكِّر الأجيالَ بمناقبه وبطولاته وبطولات أمثاله.
فالحديث عن العلامة الشيخ العربي التبسي، حديثٌ عن نموذج للعالِم العامِل،
وعن صورة ناصعة للعمامة الرائدة التي لا تُقاد، والفكر الحر الذي لا
يُساوَم، والنفس الأبية التي لا تُشترى، والعزيمة الصلبة التي لا تخور.
والحديث عن الشيخ التبسي، حديث عن رجلٍ عاش للإسلام دينا وللجزائر وطنا
وللعربية لغة، وعن مجاهد كَرِهَ الاستعمارَ كما يَكْرَهُ أنْ يُلْقَى في
النار وعاش ثائِرًا عليه بكل ما يملك، ومُحرِّضًا على ذلك قدر المستطاع،
وأحَبَّ ثورةَ التحرير المباركة، وآمن بها واحتضنها، وضحى لأجلها،
وصَيّرَها أَوْلَى أولوياته وشغلَه الشاغل، إيمانا منه بحتميتها وضرورتها
لخلاص الجزائر من عبوديتها.
وهذه السطور القليلة مساهمة متواضعة، ومحاولة بسيطة للمشاركة في هذه
الذكرى، ووقفة سريعة عند أهم محطات حياة الشيخ العربي التبسي رحمه الله،
علّها تُبرِز بعض الجوانب الحية من حياته للأجيال التي لم يُرَد لها أن
تعرف الشيخ أوتسمع عنه في زمن الردة والرداءة.
نشأته وتكوينه العلمي
ولد الشيخ العربي بن بلقاسم بن مبارك فرحات التبسي بناحية آسطح جنوب غربي
مدينة تبسة سنة 1895 في عائلة أمازيغية تنتمي إلى قبائل النمامشة الكبيرة
والمشهورة في شرق الجزائر.
بدأ حياته العلمية الأولى بحفظ القرآن كما جرت عليه عادة الكثيرين في
المجتمع الجزائري آنذاك وذلك على يد والده الذي كان معلما لأبناء القرية.
بعد وفاة والده سنة 1903 قرّر الرحلة في طلب العلم، فكانت أوّل محطة توقف
بها هي »زاوية خنقة سيدي ناجي« جنوب شرق مدينة خنشلة في الأوراس وذلك سنة
1907 أين أمضى ثلاث سنوات. في سنة 1910، رأى أهلُه أن يرسلوه إلى بلدة
نفطة بالجنوب التونسي ليلتحق بزاوية الشيخ مصطفى بن عزوز والتي سبق لوالده
أن تعلم فيها من قبل، وهناك شرع التبسي في دراسة العلوم الشرعية والعربية.
بقى في تلك الزاوية إلى غاية سنة 1914 أين قرّرالإنتقال إلى »جامع
الزيتونة« الذي درس فيه مدةً قاربت سبع سنوات ثم شدّ الرحال إلى القاهرة
سنة 1921 ليتابع دراساته العليا في »جامع الأزهر« وحصل على درجة العالمية.
العودة إلى الجزائر وأعماله فيها
عاد الشيخ التبسي إلى الجزائر بعد أن أمضى عشرين عاما من عمره في التحصيل
العلمي، بدءًا ببلده الأصلي الجزائر ثم تونس وانتهاء بمصر.
وفور عودته من القاهرة سنة 1927، إستقر بمدينة تبسة وجعلها مركزا لانطلاق
عمله الإصلاحي الذي كان يؤمن به. فبدأ في بداية الأمر بالتدريس والخطابة
وتعليم الصغار والكبار في مسجد صغير بوسط المدينة. وعندما اكتظ ذلك المسجد
برواد دروسه وحلقاته العلمية، إضطر الشيخ إلى الانتقال بهم إلى الجامع
الكبير في المدينة والذي كان يومها خاضعا لإشراف إدارة الاحتلال الفرنسي.
لكنه لم يلبث كثيرا حتى منعته تلك السلطات من النشاط في ذلك الجامع وذلك
بإيعاز من بعض رؤوس الطرقية وبعض المتعاونين مع تلك الإدارة من الجزائريين
المعارضين للإصلاح، ممّا اضطره إلى العودة مرة أخرى إلى النشاط في المسجد
الصغير الذي بدأ منه في أول الأمر.
كان الشيخ التبسي يركز في دروسه وخطبه على جوانب الإصلاح في أمور العقيدة
وتطهيرها من الخرافات والبدع التي علقت بأذهان الناس من جرّاء نفوذ السلطة
الدينية الطرقية في نفوسهم وتأثيرها على عقولهم، إلى جانب التركيز على
الأمراض الإجتماعية المنتشرة آنذاك وآثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع،
وعلاقة الاستعمار بما كان يعانيه المجتمع من ضيق وعناء في أمور الدين
والدنيا.
بعد انتشار أفكار الشيخ الإصلاحية في تبسة وضواحيها وإقبال الناس على
دروسه وجلساته، اشتدت المضايقات عليه وعلى أنصاره مِن قِبَل إدارة
الاحتلال وأعوانها من الطرقيين والانتفاعيين، فنصحه الشيخ ابن باديس
بالخروج من تبسة إلى مدينة سيق بغرب الجزائر. وكان أهلها قد بنوا مدرسة
جديدة دعوا الشيخ التبسي لإدارتها،(1) وذلك بترتيب مسبق بين أهل سيق
والشيخ عبد الحميد ابن باديس.(2) وصل الشيخ التبسي إلى سيق سنة 1930وشرع
في عمله فيها مترددا بين فترة وأخرى على تبسة إلى غاية سنة 1933 حيث قرّر
العودة إليها مرة أخرى بعد إلحاح أهلها عليه وحرصهم على بقائه بينهم.(3)
وكان الشيخ قد أشرف على تكوين »جمعية تهذيب البنين والبنات« في تبسة ثم
قام بإسمها مع أنصار الإصلاح في المدينة بتأسيس مدرسة عصرية كبيرة إلى
جانب مسجد حر بعيد عن قبضة إدارة الاحتلال. وضرب أهلُ تبسة أمثلةً رائعة
في التضحية والبذل والعطاء في إنجازهما، ومما رواه مالك ابن نبي في هذا
الشأن أنّ الجميع أسهم في البناء كل حسب مقدوره، وكان منهم نجار تطوع بكل
ما يتصل بأعمال النجارة مجانا، مع أنه لم يكن أمرا هينا، حتى أنّ امرأة
عجوزا أتت بديك لها لتساهم به في ذلك العمل العظيم رغم أنه كان كل ما
تملك.(4) وقد بلغ عددُ تلاميذ تلك المدرسة سنة 1934 خمسمائة من البنين
والبنات.
وفي العموم فقد ساهمت جهود الشيخ التبسي الدعوية الإصلاحية مساهمة واضحة
في إعادة تشكيل التركيبة الإجتماعية والفكرية للمجتمع التبسي، »فانضم تحت
لواء الإصلاح حتى عرابدة المدينة ومدمنوها العاكفون على الخمر«، بل ومنهم
من أبلى بلاء حسنا بماله وبكل ما يملك في مؤازرة الدعوة الإصلاحية.(5)
في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
لم يكن تَعَرُّفُ الشيخ التبسي على الفكر الإصلاحي لأول مرة مِن خلال
جمعية العلماء، وإنما كانت له علاقة سابقة به قبل تاريخ إنشائها. فقد كان
يتبناه منذ أيام الدراسة، ذلك أنه كان منذ العشرينات، وحينما كان طالبا
بجامع الأزهر، يقوم بنشر عدد من المقالات الإصلاحية في صحيفة النجاح وكذلك
الشهاب. ولم تكن مقالاته تلك تختلف في عمومها من حيث التصور العام
والأهداف عمّا كان يطرحه الشيخ ابن باديس حتى مِن قَبل أن يرى أحدُهما
الآخر.(6)
منذ اللحظات الأولى لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931،
كان الشيخ العربي التبسي أحد أعضائها البارزين حيث عُيّن كاتبا عاما لها
سنة 1934، وعندما توفي رئيسها الأول الشيخ ابن باديس في 1940، وبينما كان
نائبه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في منفاه، قاد الشيخ التبسي ومَن معه
مِن إخوانه العلماء الجمعيةَ بكل مهارة وحنكة إلى أن أُفرج عن الشيخ
الإبراهيمي سنة 1943 فباشر عملَه كرئيس للجمعية، فيما واصل الشيخ التبسي
عملَه فيها كنائب له.
ولقد كان تأسيس جمعية العلماء ثم عضوية الشيخ التبسي فيها بمثابة استمرار
لنشاط هذا الأخير الذي بدأه منذ عودته إلى الجزائر. غير أن ذلك النشاط صار
أكثرَ توسعًا وكثافةً وتنوعًا من جهة، وأبعدَ رؤية وأكثرَ تنظيمًا من جهة
أخرى، حيث أصبح يعمل منذ تاريخ تأسيس تلك الجمعية من خلال مؤسسة تتبنى
العمل الجماعي تفكيراً وممارسةً، وذلك كأساس مهم ضمن خطة مُوَحَّدة وأهداف
مرسومة ومنهج مُحدَّد.
وكنتيجة لسعة خبرة السيخ التبسي وقدراته في مجال التعليم إدارةً وتدريسًا،
فقد وجدته جمعيةُ العلماء أفضلَ مَن يخلف الشيخ ابن باديس في تلاميذه بعد
وفاته، فكان »الكفءَ المُجْمَع على كفاءته في هذا الباب« (7) كما وصف
الشيخ الإبراهيمي. فاضطلع الشيخ العربي بما كان يقوم به الإمام ابن باديس
في حياته من التعليم المسجدي وإدارة شؤون تلاميذ »الجامع الأخضر«، ثم
تحمَّل مسؤولية أولئك التلاميذ من حيث التعليم والإيواء عندما اضطرت جمعية
العلماء إلى نقلهم من قسنطينة إلى مدينة تبسة. فقام الشيخ التبسي وأعوانه
وأنصار الإصلاح من أهل تبسة خير قيام بما أُسند إليهم حسب تصريح الشيخ
محمد البشير الإبراهيمي رئيس الجمعية آنذاك.
وكان من آثار ذلك التعليم المبارك الذي دام عدة سنوات في مرحلته
الانتقالية، أنْ تَشجَّع الشبابُ على الإقبال على العلم والرحلة في طلبه،
فرَحَلَ المئاتُ منهم إلى »الزيتونة« بتونس، والعشرات إلى »القرويين«
بالمغرب وبعضهم إلى »الأزهر«،(9) وكان من تلاميذ الشيخ التبسي في ذلك
العهد رجالاً كانوا زينة مدارس الجزائر، ومنهم مَن هاجر إلى الشرق ليكمل
علمه فَأَوْفَى وبرز.(10)
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أن الشيخ العربي التبسي كان يقوم
بتلك الأعمال مُتطوعا ومن دون مقابل مادي، وكان مُصِرًّا على التبرع
بأعماله خالصة للّه ثم للعلم، كما جاء في نص بيان المجلس الإداري لجمعية
العلماء المُوَجّه للأمة الجزائرية وبإمضاء رئيسها الشيخ الإبراهيمي
بتاريخ 19 اكتوبر 1943.(11)
لقد أدركت جمعية العلماء أنّ رحلة أبناء الجزائر إلى خارج بلادهم وقطع
المسافات البعيدة لطلب العلم في مستوياته الأولى، إنَّما هوإهدار للجهد
والأموال وليس من العقل والصواب، وأنه لا يجب أن يفعل ذلك إلا من استكمل
تعليمه في مراحله الأولى وكان استعداده وافيا لتلقي العلوم في مستوياتها
العليا، فهناك فقط تَحسُنُ الرحلة وتكون لها فائدة.(12)
فقامت الجمعيةُ بعد رسوخ تلك القناعة، على العمل على إنشاء مؤسسة تعليمية
تضطلع بسد ذلك الفراغ الرهيب الذي فرضته يَدُ التخريب الاستعمارية التي
طالت مؤسسات الجزائر العلمية العليا منذ احتلالها للبلاد. فتم للجمعية ما
تمنت وتحقق الحلم الذي كان يراود الشيخ ابن باديس منذ أن وضع اللبنة
الأولى في التعليم المسجدي بمدينة قسنطينة. وتم افتتاح »معهد عبد الحميد
ابن باديس« في قسنطينة سنة 1947 على أمل -آنذاك- أن تفتح الجمعيةُ بَعده
مثيلين له أحدهما في مدينة الجزائر والآخر في تلمسان بغرب البلاد.(13)
ونذكر في فضل ذلك المعهد العظيم شهادةً لأحد علماء »جامعة القرويين« الشيخ
محمد التواتي وهومن أصل جزائري، رواها د. عبد المالك مرتاض الذي عاشها
بنفسه، حيث أنه لما ذهب للدراسة في تلك الجامعة العتيقة وجلس لذلك الشيخ
لاختبار القبول، كان من جملة ما سأله كم يحفظ من الشِّعر، فأجابه بأنه
يحفظ أكثر من ألفي بيت من الشعر العربي الرصين، ثم سأله عن المدة التي
قضاها طالبا بمعهد عبد الحميد ابن باديس، فلما أدرك أنها لم تكن أكثر من
أربعة أشهر، أعجب لذلك وقال له بأن معهدا يحفظ فيه تلاميذه هذا الكم من
الشعر وبتلك النوعية وفي مثل تلك المدة لمعهد عظيم.(14)
ونظرا لأهمية ومكانة ذلك الصرح العلمي الكبير في قلوب علماء الجمعية وما
كانوا يعقدونه عليه من آمال، فلم يكن في نظرهم من يشرف عليه-حينئذ- أفضل
من الشيخ العربي التبسي الذي أسندت إليه إدارته والإشراف على التعليم
العالي فيه. وقد بين ذلك بوضوح تصريح الشيخ الإبراهيمي في هذا الشأن حيث
قال: »وأما الإدارة فقد كانت -في رأيي- وما زالت أصعبَ من المال. لأن
الصورة الكاملة التي يتصورها ذهني للإدارة الرشيدة الحازمة اللائقة بهذا
المعهد العظيم، نادرة عندنا، ونحن قوم نقرأ لكل شيء حسابه. ولا نُقدّم
لجلائل الأعمال إلا الأكفاء من الرجال. وقد كنت مُدّخرًا لإدارة المعهد
كفؤََها الممتاز وجذيلها المحكك الأخ الأستاذ العربي التبسي...«(15)
ولم يكن قبول الشيخ التبسي لتلك المسؤولية الجديدة بالأمر الهين فلقد كان
على رجال الجمعية وعلى رأسهم رئيسها الشيخ الإبراهيمي بإقناعه هوأَوَّلا
بذلك، ثم إقناع أهل مدينة تبسة ثانية عن العدول على إصرارهم على عدم
التفريط في الشيخ هذه المرة بتركه مغادرة مدينتهم، حيث كانوا يعدون انتقال
الشيخ التبسي عنهم كبيرة يرتكبها مَن يتسبب فيها.(16)
فما كان من أهل مدينة تبسة في الأخير إلا الاقتناع بوجهة نظر جمعية
العلماء وأهمية انتقال الشيخ التبسي إلى عمله الجديد في قسنطينة وحاجة ذلك
العمل إلى قدراته وإلى شخصية علمية مثله. وكان مما قاله الشيخ الإبراهيمي
لهم: »إن الشيخ العربي التبسي رجل أمة كاملة لا بلدة واحدة، ورجل الأعمال
العظيمة لا الأعمال الصغيرة«. فرضوا وسلموا خاصة بعد أن تعهدت لهم الجمعية
بمسؤولية تأمين مشاريعهم العلمية والدينية بإيجاد من يخلف الشيخ العربي
فيها.(17)
عندما انتقل الشيخ العربي التبسي إلى قسنطينة للعمل في »معهد عبد الحميد
ابن باديس«، تعرّف المعلمون والطلبة على السواء على شخصية جديدة في
التضحية والجدية ونكران الذات في آداء الأعمال والواجبات. وقد سجل رئيس
الجمعية حينئذ الشيخ الإبراهيمي شهادات قيِّمة كثيرة حول بعض تلك الصفات
وغيرها المتجسدة في شخصية الشيخ التبسي وأعماله في المعهد وغيرها. وكان
مما أعُجب به الشيخ الرئيس من تلك الصفات، القدوة في التضحية في العمل
وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها الشيخ التبسي أمام هيئة التدريس في
المعهد في اجتماع لتقرير منهاج سير التعليم فيه. وكان مما جاء في كلمته
تلك ما يلي:»إن التعليم بوطنكم هذا، وفي أمتكم هذه ميدان تضحية وجهاد، لا
مسرح راحة ونعيم. فلنكن جنود العلم في هذه السنة الأولى، ولنسكن في المعهد
كأبنائنا الطلبة، ولنعش عيشَهم: عيش الاغتراب عن الأهل والعشيرة ولا
تزورزهم إلا لماماً. أنا أضيقكم ذرعًا بالعيال للبعد وعدم وجود الكافي،
ومع ذلك فها أنا فاعل فافعلوا. وها أنذا بادئ فاتبعوا«.(18) فكانت كلماته
تلك كما يروي لنا الشيخ الإبراهيمي » مُؤثرة في المشائخ، ماسحة لكل ما كان
يساورهم من قلق... ومضت السنة الدراسية على أتم ّ ما يكون من النظام
الإداري، وعلى أكمل ما يكون من الألفة والانسجام بين المشائخ بعضهم مع
بعض، وبينهم وبين مديرهم، حتى كأنهم أبناء أسرة واحدة، دبّوا على حضن
واحدة، وشبّوا في كنف واحد، وربّوا تحت رعاية واحدة، توزّع الحنان
بالسوية، وتبني الحياة على الحب. وأنّ مرجع هذا كله إلى الأخلاق الرضية
التي يجب أن يكون مظهرها الأول العلماء«.(19)
كما أثرت أخلاقه وسيرته تلك في هيئة التدريس فصار قدوة لهم في أداء الواجب
بكل تضحية وتفان، ويصف الشيخ الإبراهيمي شيئا من ذلك فيقول: » لقد حدثني
المشائخ في الأشهر الأخيرة -أي منذ تولي الشيخ التبسي إدارة المعهد- فرادى
ومجتمعين بأنهم انجذبوا إلى العلم انجذابًا جديدًا، وحببت سيرةُ الأستاذ
التبسي التعليم إليهم على ما فيه من مكاره ومتاعب وأنهم أصبحوا لا يجدون
بعد جهد سبع ساعات متواصلة يوميًا، نصبًا ولا لغوبًا«.(20)
وكان من صفات الشيخ العربي أيضا في إدارته للمعهد ما ذكره الشيخ
الإبراهيمي مِن أنّ » الأستاذ التبسي في إدارته يتساهل في حقوق نفسه
الأدبية إلى درجة التنازل والتضييع، ولا يتنازل في فتيل من النظام أوالوقت
أوالأخلاق أوالحدود المرسومة«.(21)
ولم تكن نشاطات الشيخ التبسي وأعماله تقتصر على إدارة المعهد والتدريس فيه
فقط، لكنها كانت أوسع من ذلك، فشملت غير ذلك من الأعمال كالصحافة والخطابة
والوعظ والإرشاد، والتنقل بين مدن الجزائر وقُراها المختلفة بتكليف من
المجلس الإداري للجمعية لتفقد سير أعمالها فيها وسبل تطويرها واستنهاض
جهود الأمة للمساهمة في تأييدها ومساعدتها.(22)
ولم يختم الشيخ التبسي حياتَه العملية في جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين، حتى أشرف إلى جانب إدارة المعهد، على إدارة صحيفة »البصائر«،
بالإضافة إلى ممارسة مهام رئيس جمعية العلماء مباشرة داخل الجزائر بعدما
خرج رئيسُها الشيخ الإبراهيمي إلى الشرق سنة 1952 بتكليف من الجمعية.
ولقد برَع الشيخ العربي التبسي بأعماله وصفاته التي كانت محل تقدير
واحترام الكثير من أهل العلم والسياسة في الجزائر. وقد سجل لنا جانبا من
تلك الصفات مَلِكُ اللغة العربية والبيان في العصر الحديث الشيخ محمد
البشير الإبراهيمي في شهادته التي جاء فيها: »إنّ التبسي -كما شَهِد
الاختبار وصدقت التجربة- مدير بارع، ومُرَبٍّ كامل خرّجته الكليتان
»الزيتونة« و»الأزهر« في العلم، وخرّجه القرآنُ والسيرة النبوية في
التديّن الصحيح والأخلاق المتينة، وأعانه ذكاؤه وألمعيتُه على فهم النفوس،
وأعانته عفّتُه ونزاهتُه على التزام الصدق والتصلب في الحق وإن أغضب جميعَ
الناس، وألزمته وطنيتُه الصادقة بالذوبان في الأمة والانقطاع لخدمتها
بأنفع الأعمال، وأعانه بيانُه ويقينُه على نصر الحق بالحجة الناهضة
ومقارعة الاستعمار في جميع مظاهره. فجاءتنا هذه العواملُ مجتمعة منه برجل
يملأ جوامع الدين ومجامع العلم ومحافل الأدب ومجالس الجمعيات ونوادي
السياسة ومكاتب الإدارات ومعاهد التربية«.(23)
الشيخ التبسي والاحتلال: من المضايقة إلى الاختطاف
عرفنا فيما سبق بأن الشيخ العربي التبسي قد واجه كغيره من علماء الجمعية
مضايقات شديدة من قِبَل إدارة الاحتلال. ولم يكن مَنْعُه من التدريس في
الجامع الكبير في تبسة -وما تلاه من ضغوط اضطرته إلى مغادرة المدينة إلى
غرب البلاد- آخرَ حلقة في سلسلة تلك المضايقات التي مُورِست عليه شخصيا
دون التطرق إلى ما مسّه منها ضمن الإطار العام للجمعية.
فقد قامت سلطات الاحتلال الفرنسية باعتقاله سنة 1943 بتهمة التآمر على أمن
فرنسا وذلك مِن خلال الاتصال بالألمان إبان الحرب العالمية الثانية، وتم
على إثر ذلك سجنه لمدة ستة أشهر قضاها بين سجن لامبيز (تازولت) بباتنة
وسجن قسنطينة.(24)
وكان اتهامه ذاك ثم سجنه، قد تم على إثر حدث مهم له علاقة وطيدة بقناعة
الشيخ التبسي الراسخة منذ تلك الأيام بضرورة المواجهة المسلحة ضد
العدومهما طال الزمن. فقد حدث أن جاءه بعضُ ممن يحبه من الجزائريين ويثق
في مشورته يخبره بأنهم عثروا على كمية من الأسلحة كان قد ألقى بها الألمان
على أطراف الحدود الشرقية للبلاد، على أمل أن يستخدمها الجزائريون ضد
فرنسا. لكن فرنسا تفطنت للأمر وطلبت من سكان تلك الجهات تسليم ما عثروا
عليه من الأسلحة، فأراد السكان استشارة الشيخ في ذلك، فأشار عليهم بأنه
مادامت فرنسا قد كشفت الأمر، فعليهم ردّ كيدها بتسليم جزء قليل منها على
أنه كل الموجود، وإخفاء ما تبقى منها في مكان آمن ليوم سيكونون في أشد
الحاجة إليها، وقد كان بين أولئك مَن أوشى بالشيخ ونَقَلَ مضمون تلك
الوصية إلى السلطات الفرنسية فأوقفته.(25)
وعلى إثر أحداث الثامن من شهر ماي 1945، قامت السلطات الاستعمارية
باعتقاله مرة أخرى مع مجموعة من زعماء الجزائر في الحركة الإصلاحية
والوطنية، كان منهم رئيس الجمعية آنذاك محمد البشير الإبراهيمي، وذلك
بتهمة التحريض على الثورة ضد الاحتلال. وقد تم الإفراج عنه في نهاية سنة
1946.
عند اندلاع ثورة التحرير الجزائرية المباركة في الفاتح من نوفمبر 1954،
كان الشيخ العربي التبسي أحد أبرز العلماء الذين أيدوها وناصروها، كما
شجّع أبناءَ جمعية العلماء على الانضمام إلى صفوفها. (26) وكان يقوم
بدعمها ماديا ومعنويا من خلال خطبه التي أزعجت كثيرا سلطات الاحتلال.
بالإضافة إلى كل ذلك، فقد كانت للشيخ -كرئيس لجمعية العلماء داخل الجزائر-
علاقات تنسيق وعمل وثيقة مع بعض قيادات الثورة آنذاك من أمثال زيغوت يوسف
وعبان رمضان وشيحاني بشير وغيرهم.(27)
أما العقيد عميروش فكان على اتصال مستمر به عن طريق تلميذه الشيخ إبراهيم
مزهودي تارة وبواسطة الشيخ الشهيد الربيع بوشامة تارة أخرى. وقد تعاونت
الجمعية معه في مجالات كثيرة كان منها مثلا تزويد جهاز المسؤولين
السياسيين بالإطارات الكفأة وكذلك المعلمين، وتزويد ولايته ما كان يلزمها
من آلات الطبع والكتابة والسحب.(28)
ورغم أن تلك الاتصالات والأعمال بين الشيخ التبسي -كرئيس مباشر للجمعية-
وقيادة الثورة كانت تتم في سرية تامة وفي أغلب الأحيان عبر رسل يثق بهم
الطرفان، فإن السلطات الفرنسية كانت تدرك آنذاك خطورة التحاق شخصية في وزن
الشيخ العربي التبسي بالثورة. فأرادت أن تتدارك الأمر بأسلوب آخر منطلقة
من إيمانها بثقله العلمي في المجتمع الجزائري، فقامت بعدة محاولات
لمفاوضته عن طريق مندوبين عنها لحثه على السعي لإقناع مَن يستطيع مِن قادة
الثورة بإيقافها من جهة، وبالتأثير بنفسه على الجزائريين بعزلهم عنها
وإقناعهم بعدم دعمها واحتضانها من جهة أخرى. لكن الشيخ التبسي المؤمن
بالثورة والمتشبث بها، رفض الخضوع لتلك الضغوط وردَّ على مفاوضيه من
الإدارة الفرنسية بطرق كان يتفادى بها شبهة الانضمام للثورة. فكان ممَّا
قاله مثلا لكاتب الحزب الاشتراكي الفرنسي آنذاك: »إنّ الجهة الوحيدة التي
لها الحق في التفاوض في مسألة الثورة هي جبهة التحرير الوطني أومَن
تٌعيِّنُه لينوب عنها في ذلك«.(29)
ثم تكررت تلك المحاولات الفرنسية تباعًا وبأشكال مختلفة وكان منها إقحام
الإعلام الفرنسي
في ذلك مباشرة، كإرسالهم له مثلا مبعوث صحيفة Le Monde
في يناير 1957 لمقابلته للغرض ذاته، فأدرك الشيخُ مُرادَ المقابلة ورفض استقباله والحديث إليه.(30)
ولمّا يئِست سلطةُ الاحتلال من جرّه إلى معسكرها في هذه القضية الخطيرة،
ورأت عزمَه وصلابتَه وصمودَه أمام أساليب الترغيب والترهيب، وأدركت خطورة
وجود وبقاء مثل تلك الشخصية العلمية البارزة إلى جانب الثورة، قررت
تصفيتَه والتخلصَ منه. ففي الساعة الحادية عشر ليلا من اليوم الرابع من
رمضان الموافق لليوم الرابع من شهر ابريل 1957، إقتحمت مجموعةٌ إرهابية من
الفرنسيين التابعين لفرق المظلات ويقال على يد شرذمة من المجموعات
الإرهابية »اليد الحمراء« سكنَ الشيخ العربي التبسي ببلكور بعاصمة
الجزائر، واقتادته إلى مصير مجهول لم يُعلم إلى يوم الناس هذا. (31)
فرحم اللهُ الشيخ العربي التبسي وألحقه بالنبيين والشهداء والصديقين وحسن
أولئك رفيقا، ولا حَرَمَ اللهُ أرحامَ نساء الأمة من أن تلد مثلَه وأفضلَ
منه